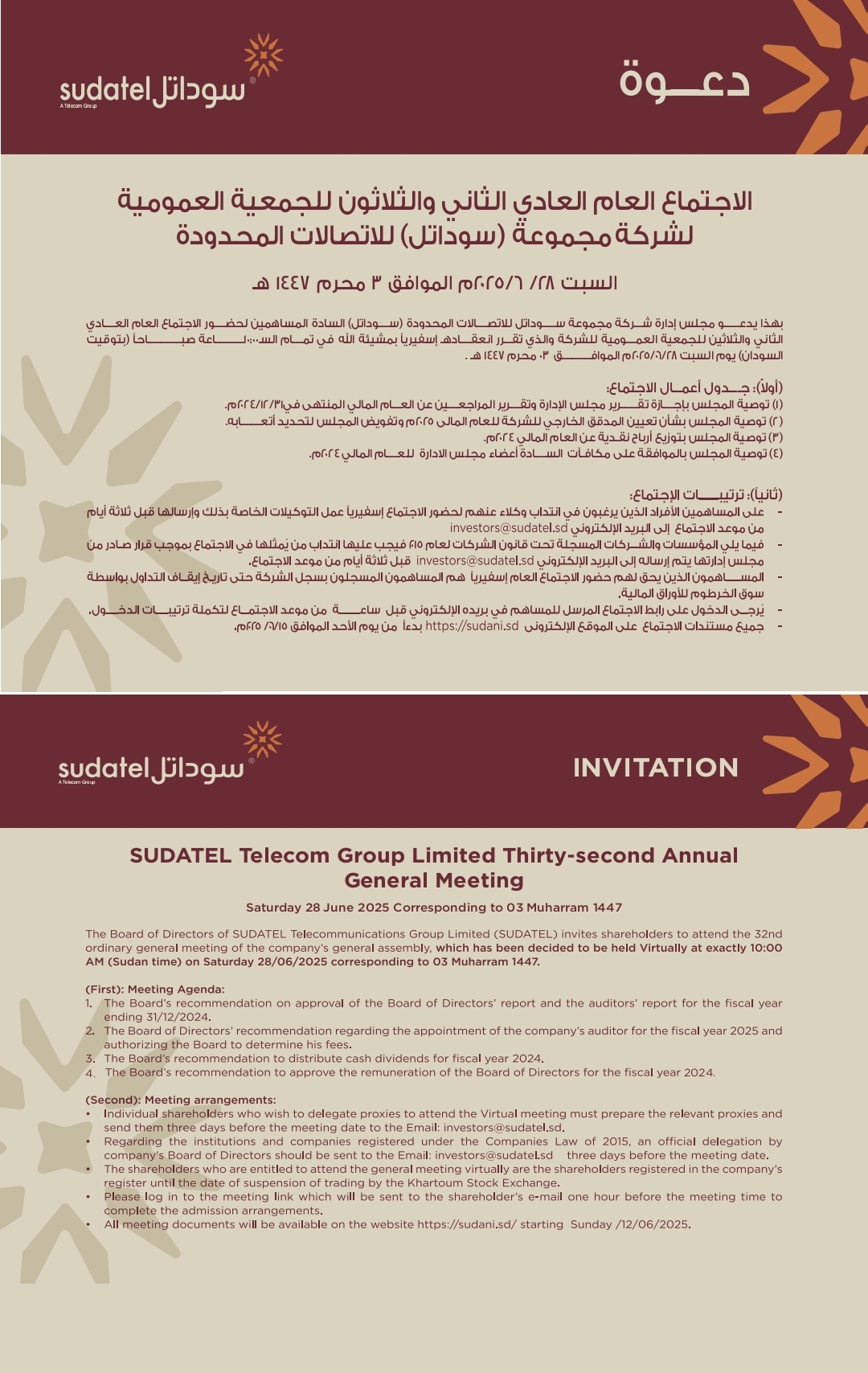محمد عثمان الشيخ النبوي يكتب : ..بهدوء و تدبر..مصيدة الديون… بين فخّ التبعية وفرصة التحرير

محمد عثمان الشيخ النبوي يكتب : ..بهدوء و تدبر..مصيدة الديون… بين فخّ التبعية وفرصة التحرير
منذ سبعينيات القرن الماضي، مثّل كتاب «مصيدة الديون: صندوق النقد الدولي والعالم الثالث» للباحثة الأمريكية شيريل بايَر علامة فارقة في النقد الاقتصادي العالمي، إذ كان من أوائل المؤلفات التي تجرّأت على تفكيك البنية العميقة للنظام المالي الدولي وكشف الوجه الخفي لما يُسمّى بالمساعدات الإنمائية. صدر الكتاب عام 1974 عن دار منتلي ريفيو برس في نحو مئتين وخمسين صفحة، وظلّ منذ ذلك الحين أحد المراجع الكلاسيكية التي أعادت تعريف العلاقة بين الشمال الغني والجنوب الفقير، بين الدائن والمدين، وبين من يملك المال ومن تُفرض عليه سياساته.
تبدأ الكاتبة من ملاحظة بسيطة ولكنها حاسمة: أن القرض ليس أداة محايدة، وأن المديونية ليست مجرد معاملة مالية بين دولتين، بل منظومة سياسية متكاملة تُفضي تدريجيًا إلى تقليص سيادة الدول النامية، وتحويل قراراتها الاقتصادية إلى رهينةٍ لشروط المؤسسات المانحة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وتشرح شيريل بايَر بلغة تحليلية دقيقة كيف تتكرر الحلقة نفسها في كل مرة: أزمة عملة أو عجز في الميزان التجاري تدفع دولة نامية إلى طلب العون، فيُمنح القرض بشروط محددة تشمل تخفيض قيمة العملة، ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وتقليص الإنفاق العام، وتحرير الأسعار والأسواق، وفتح
الباب أمام رأس المال الأجنبي دون ضوابط كافية. في البداية يُحقّق البرنامج تحسّنًا حسابيًا في المؤشرات المالية، لكن الثمن يكون باهظًا في الداخل: تراجع الإنتاج المحلي، وارتفاع الأسعار، وتآكل الدخول، واتساع الفوارق الطبقية، ما يضطر الدولة إلى اقتراض جديد لتدارك آثار القديم، فتقع في ما تسميه الكاتبة «دوامة الدين»؛ فخٌّ مغلق يصعب الفكاك منه.
وتسرد الكاتبة نماذج متعدّدة من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، لتبرهن أن ما حدث في الهند أو إندونيسيا أو البرازيل أو تشيلي ليس استثناءً، بل هو النمط نفسه: قروض قصيرة الأجل، وصفات جاهزة، إصلاحات مفروضة لا تنبع من الواقع المحلي. وتخلص إلى أن تلك السياسات، وإن بدت إصلاحية في ظاهرها، فإنها تؤسس لتبعية دائمة تُفرغ التنمية من مضمونها وتحول المعونة إلى أداة حكم اقتصادي تمارس بها القوى المالية نفوذها من وراء الستار.
غير أن التدبّر في أطروحة الكاتبة وما آلت إليه تجارب الدول المختلفة يفضي إلى نتيجة أكثر دقة وإنصافًا: أن حزمة شروط الدين ليست كلها خاطئة في ذاتها، بل إن كثيرًا منها يوافق المنطق والعقل والعلم إذا وُضع في بيئة سليمة وأُدير بعقل وطني راشد. فرفع الدعم العام عن السلع وتحويله إلى دعمٍ نوعيٍّ مباشر يستهدف مستحقيه هو في جوهره إصلاح مالي سليم يحدّ من الهدر ويحقق العدالة. والتحرير الشامل للأسعار وللعملة هو بدوره خطوة ضرورية لجذب الاستثمارات ومنع الاحتكار والفساد، بشرط أن يتم ضمن منظومة رقمنة وحوكمة متكاملة تراقب السوق وتحمي الشفافية. وكذلك ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه إلى الإنتاج لا إلى الاستهلاك، هو أساس أي نهضة اقتصادية
مستدامة. هذه كلها مبادئ صحيحة من حيث المبدأ، لكن الخلل يكمن في التطبيق، حين تُستلم القروض وتُصرف في بنود غير منتجة وغير مدروسة، فيتبخر أثرها وتُستنسخ الحاجة إلى قروض جديدة في حلقة مفرغة تُكرّس التبعية والشلل. الأخطر من ذلك أن تلك الحزم الإصلاحية تُنزَّل أحيانًا بصورة عشوائية وغير مرتبة في بيئة فوضوية بلا نظم رقابة أو شفافية، فتتحول من أدوات للنهضة إلى عوامل للانهيار، بينما تدرك الدول المقرضة ذلك تمامًا فتُبقي على القروض وسيلةً لتكبيل الدول النامية لا لتحريرها.
ورغم مرور نصف قرن على صدور الكتاب، فإن أفكاره لا تزال حاضرة بقوة، بل يمكن القول إن التاريخ اللاحق أثبت كثيرًا من تحذيراته. فقد طبّقت عشرات الدول برامج الصندوق فغرقت في الديون والانكماش، بينما نجحت قلة قليلة حين استخدمت القروض كأداة مؤقتة ضمن خطة وطنية مستقلة. وفي المقابل، أظهرت التجارب أن دولًا أخرى – مثل ماليزيا في أواخر التسعينات – رفضت قروض الصندوق وشروطه، واختارت الإصلاح الذاتي الكامل، فحرّرت اقتصادها داخليًا، وخفّضت إنفاقها غير المنتج، وأعادت بناء بيئتها الاستثمارية على أسس وطنية، فتعافت
بسرعة وأصبحت نموذجًا للنهضة السيادية. وكذلك الصين التي نهضت بلا قروض خارجية، إذ حررت أسواقها وألغت الدعم غير المنتج ووجّهت الإنفاق نحو التعليم والبنية التحتية والصناعة، فأصبحت في غضون عقود قليلة المموِّل الأكبر للعالم النامي بدل أن تكون مقترضة.
وتشترك هذه النماذج الناجحة في عناصر أساسية: التحرير الشامل من الداخل، والانضباط المالي الصارم، والحوكمة الشفافة، والرقمنة الكاملة، والقيادة الوطنية الواعية التي تستخدم أدوات السوق دون أن تخضع لها.
وفي المقابل، فإن الدول التي خضعت بالكامل لبرامج الصندوق دون أن تمتلك رؤية أو إدارة رشيدة ظلت تراوح مكانها أو تزداد تراجعًا، لأن القرض في هذه الحالة لا يغيّر بنية الاقتصاد بل يمدّ في عمر أزمته. والنتيجة التي تتكرر دائمًا أن المشكلة ليست في القرض بل في من يقوده: فحين تقود الدولة إصلاحها بنفسها يصبح التمويل وسيلة نهضة، وحين تُقاد من الخارج يتحول التمويل نفسه إلى قيدٍ جديدٍ من قيود التبعية.
لقد تجاوز كتاب شيريل بايَر حدود زمانه ليصبح نصًّا تأسيسيًا في الوعي النقدي بالعلاقات الاقتصادية الدولية، ومرجعًا لفهم كيف تتحوّل القروض إلى قيود والمساعدات إلى وسائل نفوذ، وكيف يمكن في المقابل تحويل الإصلاحات نفسها إلى أدوات تحرر حين تتولّاها إرادة وطنية حقيقية. وبعد خمسين عامًا على صدوره، يظلّ صداه حاضرًا في كل نقاشٍ جاد حول العدالة المالية والسيادة
الاقتصادية، مذكّرًا بأن طريق النهضة لا يبدأ برفض القروض وحده، ولا بقبولها عميانًا، بل بامتلاك الرؤية التي تجعل الإصلاح وسيلة استقلال لا وسيلة استعباد؛ فالأمم لا تنهض بالدَّين، بل بالعقل الذي يُحسن إدارة الدَّين، أو بتجاوزه كليًا إن لم يكن متاحًا أو مُدارًا بذكاء المقترض لا بهيمنة المقرض، وبالتحرير الشامل والحوكمة المحكمة والرقمنة المتكاملة التي تُطلق طاقاتها لتصنع مستقبلها بيديها.
وهكذا، فإنّ السودان — بما حباه الله من أرضٍ خصبةٍ ومواردٍ لا تنضب وموقعٍ استراتيجيٍّ نادر — لا يحتاج إلى انتظار قروضٍ خارجية لا بشروطٍ ولا بغير شروط. فالقروض في حقيقتها ليست متاحة أصلًا لدولةٍ تعيش ظرفًا استثنائيًا من التحديات، وإن أُتيحَت فستكون أثمانها السيادية أغلى من نفعها. الطريق أمام السودان هو تجاوز فكرة القروض كليًا، والانطلاق بإصلاحٍ داخليٍّ عميقٍ يقوم على التحرير
الشامل والحوكمة المحكمة والرقمنة المتكاملة. إنّ السودان لا يفتقر إلى المال، بل إلى النظام الذي يُحسن إدارة ثرواته واستثمار موقعه. فإذا أُصلِح الداخل وأُطلقت الطاقات وأُزيلت القيود، فإن العالم كله سيأتي إليه تمويلًا واستثمارًا وشراكةً لا منّةً. فالسودان، متى نهض بعقله ونظامه، سيكون نموذجًا جديدًا لنهضةٍ تنبع من الداخل لا من الديون؛ نهضةٍ تصنع مستقبلها بيدها، لا بيد الدائنين.