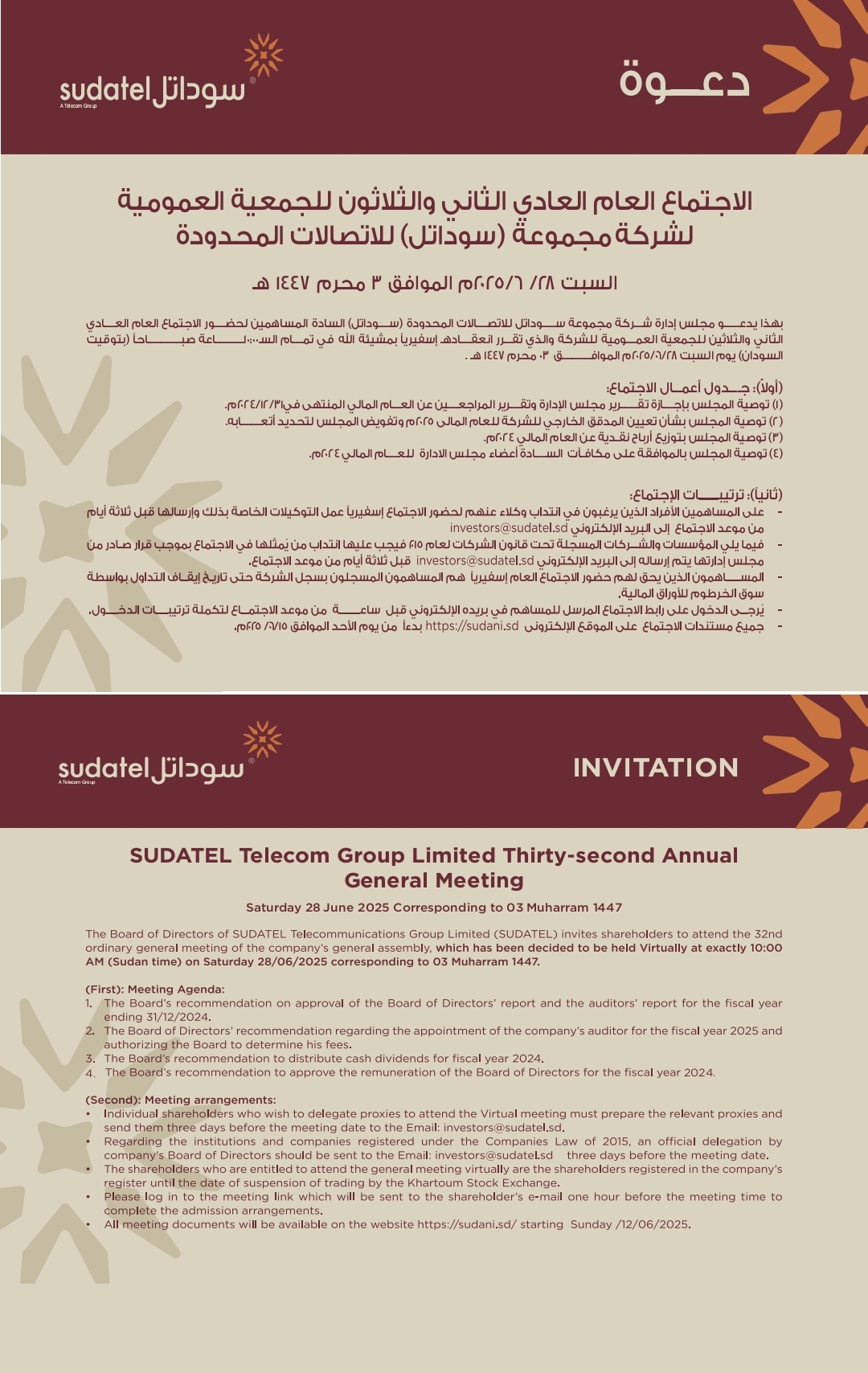محمد عثمان الشيخ النبوي يكتب: .. بهدوء و تدبر..أعجوبة السودان… أما آن لها أن تعود؟

محمد عثمان الشيخ النبوي يكتب: .. بهدوء و تدبر..أعجوبة السودان… أما آن لها أن تعود؟
منذ أكثر من قرنٍ من الزمان، وعلى سهولٍ طينيةٍ تمتد بين النيلين الأزرق والأبيض، نشأ مشروع الجزيرة ليصبح أحد أعجب النماذج الزراعية والهندسية في تاريخ البشرية. لم يكن مجرد مشروع للزراعة، بل تجربة فريدة جمعت بين فرادة الطبيعة ودقة التخطيط البشري، حتى صار اليوم أكبر مشروع ريٍّ بالجاذبية الانحدارية تحت إدارة واحدة في العالم، ونظامًا نادرًا لا شبيه له من حيث طبيعة التدفّق، واتساع المساحة، ووحدة الإدارة.
تعود فكرة المشروع إلى بدايات القرن العشرين، حين درس المهندسون البريطانيون تضاريس السودان ولاحظوا أن منطقة الجزيرة تنحدر بانسيابٍ طبيعيٍّ نحو الشمال الغربي بمتوسط مترٍ واحدٍ لكل عشرة كيلومترات، وأن تربتها الطينية الثقيلة تمنع تسرب المياه وتحتفظ بالرطوبة فترات طويلة. هذا الاكتشاف البسيط كان المفتاح لمعجزة هندسية غيّرت مصير السودان؛ إذ مكّن من إنشاء شبكة قنوات تسير فيها المياه من النيل الأزرق بالجاذبية وحدها، دون ضخٍّ أو محركات، لتروي أكثر من مليوني فدان. أُنشئ خزان سنار عام 1925 ليخزن مياه الفيضان ويطلقها وفق خطة دقيقة، فكانت تلك اللحظة ميلاد مشروع الجزيرة رسميًا.
وقد صُمم نظام الريّ في مشروع الجزيرة بطريقة علمية معجزة في بساطتها وفاعليتها، إذ تمتد القناة الرئيسة من خزان سنار لمسافة تزيد على ثمانين كيلومترًا، تتفرع منها قنوات رئيسية وفرعية وثانوية يبلغ طولها مجتمعةً عدة آلاف من الكيلومترات، موزعة على درجات انحدار محسوبة بدقة بحيث لا تتجاوز بضعة سنتيمترات في الكيلومتر الواحد. هذا التوازن بين الميل الخفيف والانسياب الطبيعي هو سرّ استدامة الريّ دون ضخٍّ ميكانيكي لأكثر من مئة عام.
في العهد الاستعماري أدار البريطانيون المشروع بانضباطٍ هندسيٍّ وعلميٍّ بالغ الدقة، عبر ما عُرف بنظام الشراكة الثلاثية بين الحكومة وشركة السودان الزراعية والمزارعين. كانت الحكومة البريطانية – السودانية مالكة الأرض والمسؤولة عن خزان سنار والقنوات الكبرى، بينما كانت الشركة البريطانية تتولى الإدارة والتمويل والإشراف الفني والتسويق، أما المزارعون السودانيون فكانوا المنتجين الفعليين في الحيازات الصغيرة التي تُقدَّر بنحو أربعين فدانًا لكل مزارع. كان العقد الثلاثي محكمًا، يضمن العدالة والانضباط ويحدد نسب الأرباح بدقة: أربعون في المئة للحكومة مقابل الأرض والمياه والبنية التحتية، وأربعون في المئة للمزارع لقاء عمله وجهده، وعشرون في المئة للشركة مقابل إدارتها وتسويقها. هذا النظام جعل المشروع نموذجًا عالميًا في التكامل بين العلم والعمل والقانون، فكانت الإدارة تعرف واجباتها والمزارع يدرك مسؤولياته، ولا مجال للفوضى أو التسيب.
وقد بلغ الانضباط في تلك الحقبة حدًّا جعل المشروع أقرب إلى منظومة هندسية منسقة منه إلى مزارع تقليدية؛ فكل تأخير في الزراعة كان يربك الجدول المائي، لذا كانت الإدارة تتابع المزارعين بدقة، ومن أهمل زراعته أو تأخر بلا عذر تُسحب منه الحيازة مؤقتًا وتُسند إلى مزارعٍ آخر لضمان انتظام الدورة، وإذا تكرر الإهمال شُطِب نهائيًا. أما من حالت دون عمله ظروف قاهرة، كمرضٍ أو وفاة، فكانت الإدارة تراعي حاله وتُعين له عاملًا مؤقتًا وتخصم جزءًا من نصيبه لاحقًا. بهذا النظام الصارم حافظ المشروع على انتظامه وإنتاجيته، حتى صار القطن السوداني من أجود أنواع العالم، وأصبح اسم الجزيرة مرادفًا للجودة والانضباط والوفاء بالعقود.
وبعد الاستقلال عام 1956 انتقلت إدارة المشروع إلى الدولة السودانية، فحافظت في البداية على النظام القائم عبر مجلس إدارة وطني، وأضافت إليه روحًا وطنية جديدة. توسّع المشروع بإنشاء امتداد المناقل، وبلغت المساحة المزروعة أكثر من 2.2 مليون فدان تضم مائة ألف مزارع. وكان المشروع يسهم بالنصيب الأكبر من ميزانية الدولة عبر حصائل الصادرات الزراعية والضرائب المرتبطة بها، حتى
صار القلب النابض للاقتصاد السوداني الحديث. مثّل المشروع وحده أكثر من نصف الناتج الزراعي، وموّل بالضرائب والصادرات إنشاء السكة الحديد والبنك الزراعي وميناء بورتسودان، كما كان الممول الرئيسي للعملة الصعبة لعقود. وكان انتظام حصائل صادرات الجزيرة من أبرز أسباب استقرار الجنيه السوداني في تلك الحقبة، حتى غدا القطن السوداني علامة على قوة الاقتصاد الوطني وثباته.
لقد نشأت حول المشروع مجتمعات زراعية متكاملة، جمعت بين المزارعين والعمّال والفنيين والإداريين، فانبثقت ثقافة عملٍ منضبطة امتزجت فيها القيم الريفية بالمعرفة الحديثة. كانت المدارس والمستشفيات والنوادي الزراعية جزءًا من البنية الاجتماعية، مما جعل الجزيرة نموذجًا فريدًا للتنمية الريفية الشاملة، لا يقتصر على الإنتاج المادي بل يمتد إلى بناء الإنسان.
إلا أن العقود التالية شهدت بداية الانحدار، إذ بدأت البيئة الكلية في البلاد تتدهور: الاقتصاد يختل، العملة تفقد استقرارها، والبيروقراطية تتضخم على حساب الكفاءة. ومع هذا التدهور البيئي العام انهار النظام الإداري الدقيق الذي كان يميز المشروع. فحين تأممت المؤسسات في عهد نميري فقد المشروع استقلاله المؤسسي، ثم جاءت الخصخصة غير المنضبطة في التسعينيات لتنسف ما تبقى من التنظيم. انسحبت الدولة من التمويل دون أن تهيئ بديلاً مؤسسياً، وغابت الشركة ذات الكفاءة العلمية والمالية، وصار المزارع وحده في مواجهة أعباء الزراعة دون دعمٍ ولا توجيه، فاختلت الدورة الزراعية وتدهورت الصيانة وقلّ الانضباط.
إنّ السبب الجوهري لتدهور مشروع الجزيرة لا يكمن فقط في ضعف الإدارة أو قلة التمويل، بل في تفكك البيئة العامة وغياب الصيغة التعاقدية المحكمة التي بُني عليها المشروع في الأصل. فحين أُلغيت الشركة المديرة ولم تُنشأ بدلاً عنها شركة وطنية أو دولية ذات كفاءة علمية ومالية وتسويقية عالية، انهار التوازن الثلاثي الذي كان يربط الدولة والشركة والمزارع بعقدٍ واضح المعالم. وبدون هذا التوازن تحولت الإدارة إلى جهازٍ بيروقراطي عاجز، والمزارع إلى منتجٍ متروك، والدولة إلى جهة مراقبة بلا أدوات تنفيذ، فضاعت هيبة المشروع وفاعليته. ولهذا، فإن إعادة إحياء مشروع
الجزيرة لا تكون بالعودة العاطفية إلى الماضي، بل بالعودة العلمية إلى نظامه المؤسسي الأصلي بصيغةٍ حديثة، تقوم على عقدٍ جديدٍ واضح البنود يجمع بين الدولة كمانحةٍ للأرض والمياه، والشركة المديرة ذات الكفاءة العالية، والمزارعين كشركاء منتجين، في إطارٍ من الشفافية والمحاسبة والحوكمة المؤسسية. هذا العقد يجب أن يكون بمستوى العقود الدولية من حيث الدقة والوضوح، ويُدار رقمياً وتحت رقابة الدولة والقانون، ليغلق كل أبواب الفساد والتقصير، ويعيد المشروع إلى مساره الطبيعي كمؤسسة إنتاجية منضبطة تقاس كفاءتها بالأرقام لا بالشعارات.
ومع أنّ الإدارة الاستعمارية للمشروع بلغت من الإتقان الهندسي والإداري ما جعلها مضرب المثل، إلا أنّها كانت تفكر بعقلية استثمارٍ سريع العائد، فركّزت على محصولٍ واحد هو القطن، وأهملت الإمكان الهائل للبستنة والزراعة المتنوعة وتربية الحيوان والصناعات المكمّلة. ولو أُدخل منذ ذلك الحين نظام زراعي-حيواني-صناعي متكامل لاستطاع المشروع أن يحقق اكتفاءً غذائيًا وازدهارًا ريفيًا شاملاً. واليوم، ومع التطور العلمي والتقني، تبرز هذه الفكرة كفتحٍ جديدٍ لمستقبل الجزيرة، إذ يمكن تخصيص أجزاء مدروسة للبستنة المنتجة، وأخرى لتربية الحيوان، وتوظيف مخلفات الزراعة والبستنة في صناعة الأسمدة العضوية والطاقة الحيوية، مع قيام الصناعات التحويلية حول المشروع من ألبانٍ وزيوتٍ وأعلافٍ ومشروباتٍ غذائية. بذلك يتحول المشروع إلى منظومة تكاملية لا تُهدر فيها الموارد بل تتولد منها موارد جديدة، ويصبح مركز إشعاعٍ للتنمية الريفية وتمكين النساء والشباب، ورافعةً حقيقيةً للاقتصاد الوطني.
غير أن هذه التصورات جميعها، مهما بلغت من دقةٍ في التصميم وكمالٍ في التنفيذ، لن تؤتي ثمارها ما لم تُنفَّذ داخل إطار إصلاحٍ وطنيٍّ شامل، يقوم على التحرير الاقتصادي الكامل، والحوكمة المؤسسية، والرقمنة الشاملة، ونفاذ القانون على الجميع بلا استثناء. فمشروع الجزيرة لا يعيش في فراغ، بل في بيئةٍ وطنيةٍ تتأثر بها وتؤثر فيها، وإذا بقيت تلك البيئة مختلةً أو مقيدةً بالبيروقراطية والجمود والتدخل السياسي، فلن يجدي أي إصلاحٍ موضعي نفعًا مهما كان متقنًا. إنّ التحرير الشامل هو الذي يطلق طاقات السوق، والحوكمة هي التي تضبطها بالعدل والشفافية، والرقمنة هي التي تجعل ذلك واقعًا منضبطًا قابلاً للقياس والمتابعة، ونفاذ القانون هو السياج الذي يحمي الجميع من الانحراف. وبهذا الإطار وحده يمكن لمشروع الجزيرة أن ينهض لا كجزرٍ معزولةٍ من الإنتاج، بل كقلبٍ نابضٍ في جسد اقتصادٍ متحررٍ من القيود، عادلٍ في نظامه، ذكيٍّ في إدارته، منفتحٍ على المستقبل.
وعندما نقارن مشروع الجزيرة بما يماثله في العالم ندرك فريد مكانته. فمشروعات الري الكبرى في باكستان والهند والصين تعتمد على الضخ وتعدد الإدارات، بينما تظل الجزيرة المشروع الوحيد الذي يجمع بين المساحة الهائلة (أكثر من مليوني فدان)، والانحدار الطبيعي المستمر، والإدارة الموحدة التاريخية. لا في أستراليا ولا في أمريكا ولا في آسيا يوجد مشروع واحد يروي هذه المساحة كلها بالجاذبية الانحدارية وحدها من مصدر واحد هو خزان سنار. وهذه الخصيصة تجعل كلفة تشغيله الأدنى عالميًا واستدامته الأعلى مقارنة بأي منظومة أخرى.
ومع تنامي التحديات البيئية في العالم اليوم، فإن لمشروع الجزيرة قيمة إضافية كونه نموذجًا للريّ منخفض الانبعاثات لا يحتاج إلى طاقة أو وقود، مما يجعله متوافقًا مع توجهات التنمية الخضراء. ومع ذلك، فإن تغيّر المناخ وارتفاع درجات الحرارة يستدعيان إعادة النظر في نوعية المحاصيل وأنماط الزراعة وتطوير نظم الصرف لمنع الملوحة والاختناق المائي، وهي كلها مجالات يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة للبحث العلمي والاستثمار الزراعي المستدام.
إنّ بعث مشروع الجزيرة اليوم ليس حلمًا مستحيلًا، بل ضرورة وطنية، فالأرض ما زالت خصبة، والبنية المائية قائمة، والخبرة البشرية موجودة، وما ينقص هو النظام: نظام الإدارة والعقد والرقابة. فإذا اجتمع هذا مع بيئةٍ اقتصاديةٍ كليةٍ عامةٍ محررة، مسيَّجةٍ بحوكمةٍ دقيقة، وخاضعةٍ لرقمنةٍ شاملةٍ تربط كل مزارعٍ بالمياه والسوق عبر منصةٍ واحدة، فسوف يعود المشروع كما بدأ، معجزةً علميةً وهندسيةً واقتصاديةً تسقي السودان وتغنيه. فمشروع الجزيرة ليس فقط قصة زراعةٍ ومياه، بل درسٌ خالد في أن نهضة الأمم تبدأ حين يُترك العلم يقود القرار، وحين تُدار الثروة بالعقل لا بالسياسة، وحين يلتقي الإنسان بالأرض في عقدٍ من الأمانة والإنتاج والعدل. وبين التاريخ والعلم، يظل مشروع الجزيرة شاهدًا على عبقرية الإنسان حين يسير مع الطبيعة لا ضدها — معجزةً نادرة، بل فريدة، لا شبيه لها على وجه الأرض.