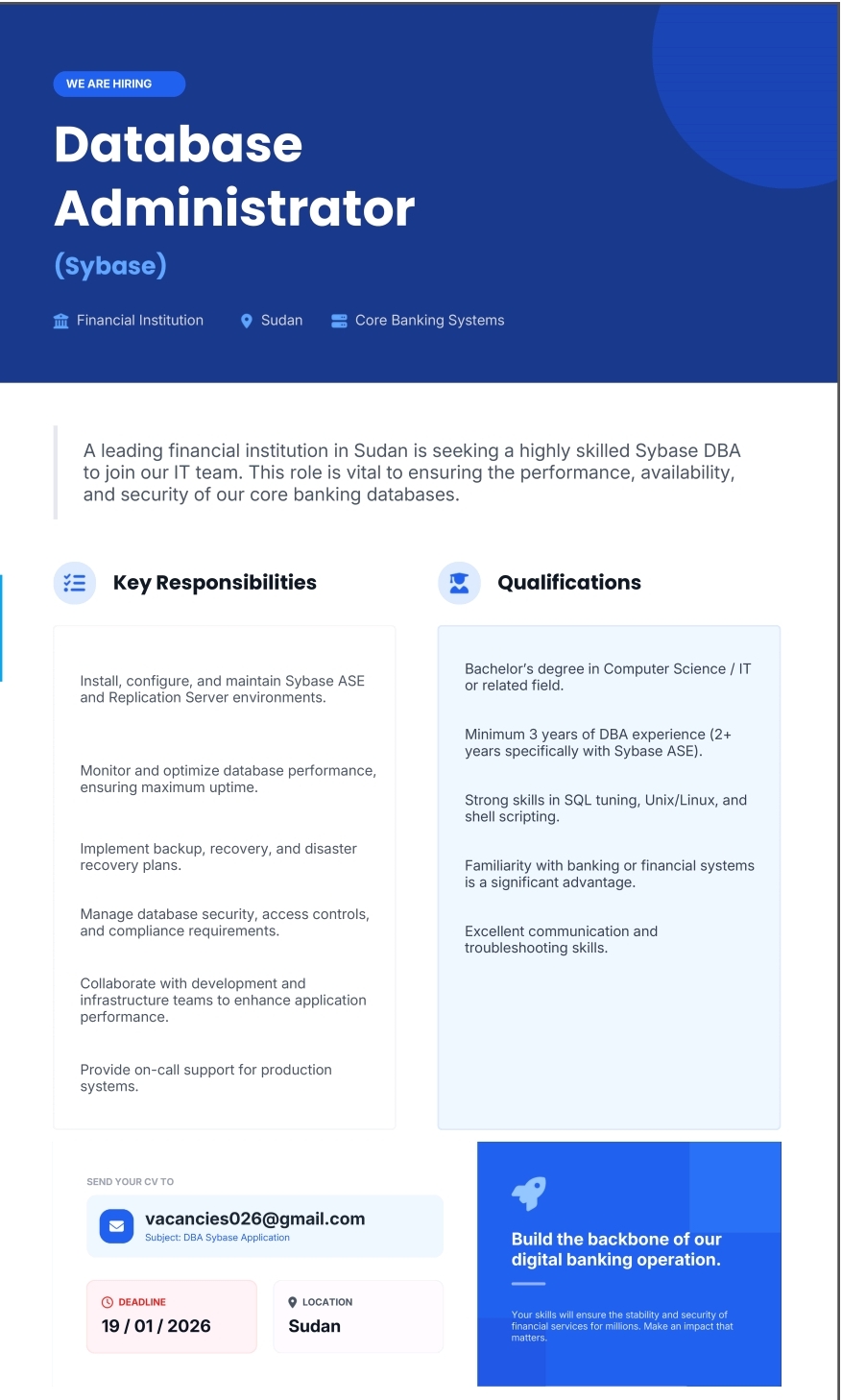محمد عثمان النبوي يكتب: .. بهدوء و تدبر..السودان: إشكالات جوهرية … وحلول جذرية

محمد عثمان النبوي يكتب: .. بهدوء و تدبر..السودان: إشكالات جوهرية … وحلول جذرية
لا يختلف اثنان اليوم على أن السودان يعيش واحدة من أعنف أزماته الاقتصادية والاجتماعية في تاريخه كله، وربما أخطرها على الإطلاق. فالأرقام صادمة في حجم الانكماش الاقتصادي، مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية والقطاع المالي والصناعي والخدمي. الحرب لم تخلق الأزمة من العدم، لكنها انفجرت فوق أرض كانت تعاني أصلًا من اختلالات تراكمت على مدى عقود، ففاقمتها ووسّعت هوّتها وضاعفت آثارها. فالدولة قبل الحرب كانت تعيش حالة إفلاس صامت: موارد قليلة، إيرادات شحيحة، عجز عن دفع رواتب عادلة، وعجز أكبر عن تمويل الخدمات الأساسية،
فتآكل التعليم، وانهارت الصحة، وضعف الأمن، وتدهورت المرافق العامة حتى تحوّلت من حقوق أساسية إلى أعباء على المواطن. أما القطاع المصرفي فكان الصورة الأوضح لعمق الاختلال، إذ كانت البنوك برساميل هزيلة وأصول ضعيفة ووساطة مالية شبه معدومة، ثم جاءت الحرب فحطّمت ما تبقّى، فأغلقت معظم الفروع وتجمّدت السيولة وانهار القطاع حتى أصبح مجموع ما تملكه البنوك السودانية أقل من رصيد بنك متوسط في دولة نامية.
وترافق ذلك مع تآكل متسارع لقيمة العملة الوطنية، وانتشار التضخم والركود، وتراجع الإنتاج والصادرات، وارتفاع البطالة واتساع الكساد. ومع غياب نظام اقتصادي منضبط تفشّى الفساد واتّسعت الفوضى الإدارية والمالية، وانهارت فكرة الـ System العام، أي النظام الكلّي الذي تقوم عليه الدول الحديثة، وترافق ذلك مع شحّ السيولة وارتفاع تكاليف طباعة العملة، وانتشار التهريب المباشر وغير المباشر، وتفاقم مشكلات اجتماعية خطيرة كالعزوف عن الزواج وارتفاع نسب الطلاق وتعاطي المخدرات وتدهور البيئة وغياب فرص العمل. كل ذلك لم يكن أعراضًا متفرّقة، بل نتيجة طبيعية لغياب الدولة الفاعلة والنظام المنضبط والاقتصاد المنتج.
ورغم هذا السواد، فإن الإجماع الإيجابي لا خلاف عليه: السودان بلد غني بموارد هائلة تشمل أراضٍ زراعية واسعة، ومياهًا غزيرة، ومعادن متعددة، وثروة حيوانية ضخمة، ومصادر للطاقة النظيفة، وموقعًا استراتيجيًا استثنائيًا على البحر الأحمر، وشعبًا شابًا ذكيًا قادرًا على النهوض متى وُفّرت له البيئة السليمة. لكن هذه الموارد بقيت أسيرة غياب الرؤية وسوء الإدارة وتخبط السياسات، بل إن جزءًا كبيرًا من الأزمات تضاعف بسبب حلول جزئية غير مدروسة
وسياسات متناقضة تُبدَّل كل بضعة أشهر. ومن أوضح أمثلتها ربط التصدير بالتجنيب ثم إلغاؤه بصورة مربكة، وإلزام المصدّر ببيع حصيلته بسعر رسمي لا علاقة له بالسوق الحقيقي، أو إلزامه باستيراد سلع لا صلة لها بنشاطه خلال فترة محددة من استلام حصيلة صادره، أو حمله على بيع الحصيلة بالسعر الرسمي الذي يمثّل خسارة مؤكدة. وكل هذه النماذج وغيرها تعكس درجة من التخبط لا يمكن أن تخرج السودان من أزمته مطلقًا، لأنها تعاقب المنتج، وتطرد المستثمر، وتقتل الحافز، وتحبس الاقتصاد داخل دائرة مغلقة من القرارات المؤقتة.
وإذا نظرنا إلى واقع السوق نفسه، سنجد أن خيار التحرير ليس مجرد اقتراح إصلاحي، بل هو في الحقيقة وصفٌ لما هو قائم بالفعل؛ فسعر الصرف في السودان محرَّر فعليًا منذ سنوات، لكنه محرر خارج القانون، في سوق موازية يمتلك زمامها أفراد، ويتحكمون فيها بلا ضوابط ولا شفافية، بينما تتعامل الدولة نفسها – في كثير من الأحيان – بسعر هذا السوق، وتتأثر به كل السلع والخدمات دون استثناء. وحين يكون السعر الفعلي هو سعر السوق الموازي، فإن القيد المفروض على السعر الرسمي لا ينتج إلا ضررًا محضًا: فهو لا يخفض الأسعار، ولا يزيد الإيرادات، ولا يحمي الفقراء، ولا يرفع الاحتياطي، ولا يقوّي البنوك. بل يخلق تشوهات،
ويغذي الفساد، ويفتح أبواب التهريب، ويحرم الدولة من مليارات تذهب إلى جيوب تجار العملة. ولهذا فإن التحرير الشامل ليس سوى تقنينٍ لما هو واقع أصلًا، لكنه يجعل هذا الواقع يعمل داخل إطار القانون، عبر البنوك والصرافات والمنصات الرسمية، بحيث تنتقل كل المنافع التي يبتلعها السوق الموازي إلى خزينة الدولة والمجتمع، وتُغلق في المقابل كل الأبواب التي تُستنزف منها موارد البلاد اليوم.
والأعجب من ذلك ما ينادي به بعضهم من دعوات لسيطرة الدولة على الاقتصاد عبر احتكار تصدير السلع الأهم كالقطن والصمغ والحبوب الزيتية والثروة الحيوانية، واحتكار استيراد السلع الكبرى كالوقود والقمح والأدوية وسائر المستلزمات الأساسية. وهذه نماذج لم يعد لها موضع في عالم اليوم، ولم تعد تُذكر إلا في دفاتر الفشل الدولي وتجارب الانهيار الاقتصادي التي دفعت ثمنها شعوبًا بأكملها.
وهنا من المهم التنبيه إلى خطأ الدعوات التي تطالب بإيقاف التعدين الأهلي، رغم أنه يشكّل اليوم المورد الأكبر لصادرات الذهب، بنسبة تقارب أو تتجاوز 80%. فملايين من المواطنين يعملون مباشرة في هذا القطاع، ويعيلون أسرهم منه، بينما يعيش ملايين آخرون – ولعلهم غالب أهل السودان – من خدمات مرتبطة به بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وقد رفع هذا القطاع عن الدولة أعباء لا حصر لها، ولولاه – بعد فضل الله – لكان الوضع أشد قتامة مما هو عليه الآن. والأفق الصحيح ليس إيقافه، بل ترشيده بيئيًا وتنظيم شراء الذهب منه رسميًا بالسعر العالمي.
ومن الأخطاء الشائعة أيضًا الدعوة لاحتكار الدولة للذهب وادّعاء تكوين احتياطي منه بمجرد قرار. فكيف تحتكر الدولة ما لا تملك؟ الذهب المنتج تقليديًا يملكه منتجوه بنسبة 80%، فهل ستوقفهم الدولة ثم تنتجه هي بدلًا عنهم؟ هذا غير ممكن لا علميًا ولا عمليًا. أما الجزء المتبقي فتنتجه شركات خاصة تُسلّم الدولة نسبتها وفق المتعارف عليه عالميًا. ولذلك فطريق الثراء الوطني لا يمر عبر المصادرة أو الاحتكار، بل عبر خلق البيئة الجاذبة للاستثمار، وتشغيل الاقتصاد الكلي، بما يسهل دخول الشركات الكبرى عبر صيغ BOT وPPP، وعبر ذلك فقط تُبنى الاحتياطيات وتستعاد القوة الاقتصادية للدولة.
وقد أصبح من المستقر في تجارب التنمية الحديثة، وفي أغلب الأدبيات الاقتصادية الجادة، أن الخروج من هذه الدائرة لا يكون إلا بتحرير شامل ومنضبط لسعر الصرف. فالمسألة لم تعد موضوعًا للجدل النظري، إذ تؤكد التجارب الناجحة أنه لا اقتصاد ينهض بوجود سعر صرف مزدوج أو مصطنع أو سوق موازٍ أقوى من السوق الرسمي، ولا دولة تجذب استثمارًا أو تدير تجارة عالمية أو تحرّك قطاعها المصرفي بوجود قيود على حركة الأموال. المطلوب إذًا ليس مجرد تخفيف للقيود، بل تحرير كامل للسعر يخضع لقانون العرض والطلب وحده، من غير أسعار تأشيرية أو منشورات يومية أو تدخلات إدارية تسحق منطق السوق.
ومع ذلك ينبغي التنبيه إلى أن ما يُسمّى في الصين بـ«المرونة المُدارة» لا علاقة له أبدًا بالسياسات التي تُطرح أحيانًا في السودان. فالصين تدير سعر صرفها لأنها تستطيع أن تديره، إذ تمتلك احتياطيات تفوق ثلاثة تريليونات دولار، وقاعدة إنتاجية وصناعية عملاقة، وقدرة هائلة على التأثير في الأسواق العالمية. إدارة السعر هناك هي إدارة القوة لا إدارة الضعف، وهي شكل من أشكال التحرير المدعوم بقدرات اقتصادية خارقة، وتفعل ذلك من أجل أهداف استراتيجية، منها المنافسة عالميًا في الصادرات. أما الدول التي لا تملك احتياطيات كبيرة، ولا تمتلك اقتصادًا منتجًا، ولا نظامًا مصرفيًا قويًا، فإن محاولة إدارة سعر الصرف تتحول تلقائيًا إلى تثبيت مصطنع يخلق فجوة بين السعرين
الرسمي والموازي، وهي الفجوة التي تلد السوق السوداء، والتهريب، وغياب التحويلات، وتراجع الثقة، وشلل البنوك، واتساع الكساد. ولهذا فإن الحالة السودانية لا تحتمل المرونة المُدارة؛ فهي ببساطة غير ممكنة، والحل الوحيد الممكن علميًا وعمليًا هو تحرير كامل للسعر وتركه لآلية العرض والطلب، ليُولَد التوازن الحقيقي أولًا، ثم يمكن لاحقًا – بعد تراكم الاحتياطيات وتدفق الصادرات – أن تُمارس الدولة ما تشاء من الإدارة الفنية إن أرادت، ولكن من موقع القوة لا من موقع الاضطرار.
ولعل من الضروري هنا تصحيح فهم شائع حول بعض الدول التي تُضرب بها الأمثال، وعلى رأسها الصين. فالصين – رغم كونها دولة قوية ذات نظام سياسي مركزي – لا تُطبّق سياسات تشبه ما يُطرح في السودان من إجبار المصدّر على بيع حصيلته بسعر رسمي، أو مصادرة العملات، أو ربط حصيلة الصادر بسقوف زمنية، أو إلزامه باستيراد سلع لا علاقة لها بنشاطه. فالصين تعمل بنظام تحويلات مُدارة ومنضبطة لا نظام تحويلات مُقيّدة، أي أنها تراقب حركة الأموال لمنع غسل الأموال وحماية الاستقرار المالي، لكنها لا تمنع المصدّر من الاحتفاظ بحصيلة صادراته، ولا من استيراد ما يشاء، ولا من تحويل أرباحه إلى أي دولة يريدها، ولا من تحويل اليوان إلى العملات الأجنبية متى شاء. ولهذا لا توجد في الصين سوق موازية، ولا سعران للعملة، ولا منشورات مصرفية يومية، لأن سعر الصرف نفسه واقعي ومدار بمرونة تستند إلى القوة، وليس مصطنعًا أو بعيدًا عن السوق، بل هو السوق نفسه.
وهنا تظهر الحقيقة التي تكاد تكون القاسم المشترك الأعظم في كل تجارب النهوض الاقتصادي المعاصر: أنه لا توجد دولة واحدة – لا في السابق ولا اليوم – قدّمت نموذجًا ناجحًا ومستقرًا في ظل اقتصاد مقيّد، أو سعر صرف مصطنع، أو تجارة محتكرة، أو تحويلات معطّلة، أو نظم مالية بلا رقمنة ولا حوكمة. كما لا توجد دولة واحدة ازدهرت بعد أن احتكرت الصادرات والواردات (عدا الدول الريعية النفطية)، أو قيّدت حركة الأموال، أو أبقت على فجوة بين السعرين الرسمي والموازي. هذه الأوضاع لا تظهر إلا في تجارب الانهيار مثل فنزويلا وزيمبابوي وعدد من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وعلى النقيض تمامًا، تظهر ثلاثية التحرير المنضبط، والرقمنة المتقدمة، والحوكمة الصارمة كقاعدة مشتركة تجمع بين كل الاقتصادات الناجحة، من سنغافورة وكوريا وتايوان ورواندا، إلى أوروبا والخليج وشرق آسيا.
ومن هنا يبرز السؤال الذي يفرض نفسه:
هل يعرف العالم نموذجًا واحدًا نجح بغير هذه القواعد؟
هل توجد دولة واحدة قيدت سعر الصرف، واحتكرت التجارة، وأوقفت تدفق الأموال، ثم خرجت من أزمتها؟
أو دولة سيطرت على الصادرات والواردات (غير النفط) ولم تنهَر؟
الجواب الذي تقدمه التجارب الحديثة مجتمعة هو أن كل مسارٍ سلك هذا الطريق انتهى إلى الفشل أو التراجع والعودة إلى التحرير والانفتاح والحوكمة.
وفي نهاية الأمر، يتضح أن الخلل لم يكن يومًا في ثروات السودان ولا في إنسانه، بل في البيئة الخانقة التي شلّت قدرته على العمل، ودفعت المسؤولين والخبراء إلى الاكتفاء بالتشكي والتباكي على فقر الدولة والشعب وقلة الإنتاج وانعدام الخدمات وتلاشي الاستثمار، دون القدرة على تقديم رؤية متكاملة للحلول الجذرية. والحقيقة أن لا سبيل للخروج من هذا الوضع إلا عبر ثلاثية تكاد تكون القاعدة المشتركة لكل تجارب النهوض في العالم المعاصر: تحرير شامل للاقتصاد وسعر الصرف، ورقمنة متكاملة، وحوكمة صارمة. ومن دون هذه الأسس، لن يكون هناك سوى مزيد من التخبط والسراب. أما بها، فمن هنا فقط يبدأ السودان التحول من الانهيار إلى الانطلاق، ومن العدم إلى البناء، ومن الأزمة إلى الدولة الحديثة القادرة على الحياة والاستثمار والإنتاج والازدهار.