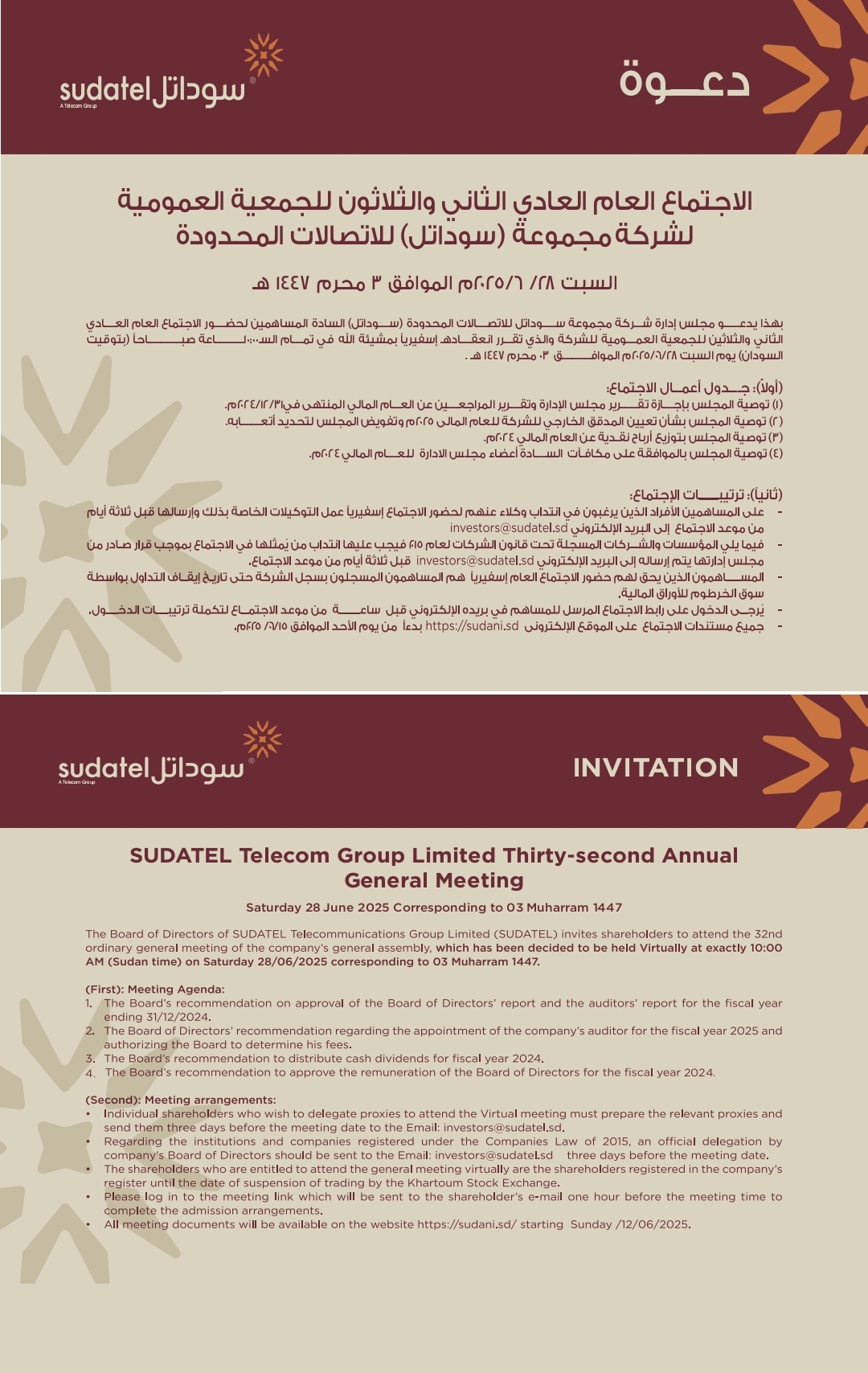محمد عثمان النبوي يكتب: .. بهدوء و تدبر..من المسؤول عن تخلّفنا؟ الخارج… أم نحن؟

محمد عثمان النبوي يكتب: .. بهدوء و تدبر..من المسؤول عن تخلّفنا؟ الخارج… أم نحن؟
حين نتأمل في جذور تخلّف الدول المستضعفة في عالم اليوم، ونقرأ تاريخها الاقتصادي والسياسي بعيدًا عن الخطابات الجاهزة، نجد أنفسنا أمام مدرستين فكريتين كبريين تتجاذبان تفسير هذه الظاهرة المتجذّرة. الأولى ترى أن التخلف صُنع — أو على الأقل رُسِّخ — من الخارج، بفعل منظومة استعمارية عالمية تعاملت مع الشعوب الضعيفة كخزان للمواد الخام وسوق للمنتجات، وأن القوى الكبرى — قديمًا وحديثًا — لم تكن يومًا معنية بنهضة هذه البلدان، بل بتكريس تبعيتها وهيمنتها عليها. والثانية تقول إن المشكلة في الداخل لا في الخارج، وإن الدول لا تُهزم إلا حين تهزم نفسها، وإن الفساد وسوء الحكم وغياب الرؤية الوطنية والتنازع الأهلي وضعف المؤسسات هي الأسباب الحقيقية التي تعطل قدرات الأمم وتبقيها على هامش التاريخ.
ويمثل المدرسة الأولى عددٌ من الكتب والمفكرين الذين وضعوا القوى الغربية في قلب المشكلة، وفي طليعتهم ولتر رودني في كتابه الشهير كيف أضعفت أوروبا أفريقيا، حيث قدّم سردية قوية عن نهب الثروات وتحويل الاقتصادات المحلية إلى تبعيات خاملة، إلى جانب أسماء مثل سمير أمين في أطروحاته حول المركز والهامش، وفرانز فانون في معذّبو الأرض، وأندريه فرانك وإيمانويل وولرشتاين في نظريات التبعية. أما المدرسة الثانية فيمثّلها تيار واسع من الكتاب الذين رأوا أن التخلف يُصنع من الداخل قبل الخارج، وأن إمكانات الشعوب تتولد أو تتعطل بحسب طبيعة مؤسساتها، وفي مقدمتهم أسيموغلو وروبنسون في كتابهما لماذا تفشل الأمم؟، وديفيد لاندز في ثروة الأمم وفقرها، وجاريد دايموند في أسلحة وجراثيم وفولاذ، ونايل فيرغسون الذي دافع — ولو بحدة — عن فكرة أن الاستعمار جلب لبعض البلاد بنى تحتية حديثة لم يُحسن استثمارها بعد الاستقلال.
وبين هذين التيارين نشأ جدل طويل اتسع لعقود: هل تخلف الدول المستضعفة مؤامرة عابرة للحدود، أم نتيجة سوء إدارة داخلية؟ هل القوى الكبرى هي التي أجهضت مشروعات النهضة، أم أن القادة المحليين هم الذين فرّطوا في بلدانهم؟ هل المشكلة “الخارج الذي ينهب”، أم “الداخل الذي لا يفهم”؟ والحقيقة — عند التدقيق — لا تقع بالكامل في كفة هذا الفريق أو ذاك، فالتاريخ لا يُختزل في طرف واحد، ولا يُقرأ بتفسير أحادي مهما بدا جذابًا أو حادًّا.
إن القراءة الهادئة تكشف أن التخلف نتاج سبب مزدوج؛ ضغط خارجي مقصود، واستكانة داخلية ممتدة. فمن جهة، لا يمكن إنكار أن القوى الاستعمارية أعادت تشكيل خرائط الاقتصاد والسياسة بما يخدم مصالحها، وأنها أبقت البلدان الضعيفة مصادر للمواد الخام، وأسواقًا مفتوحة للمنتج الأوروبي، وأن العالم الرأسمالي الحديث بُني على توزيع مختل للقوة والثروة. بل إن الاستعمار الكلاسيكي تحوّل في عصر ما بعد الجيوش إلى استعمار جديد يمارس السيطرة عبر الشركات متعددة الجنسيات، والديون، واتفاقيات التبادل غير المتكافئ، واحتكار التكنولوجيا، وفرض نماذج اقتصادية تُنتج التخلف بدل أن تقاومه. وهذه حقيقة تتكرر في كل القارات، من أفريقيا إلى آسيا إلى أمريكا اللاتينية.
ومن جهة أخرى، فإن كثيرًا من الدول المستضعفة استسلمت لهذا الوضع لعقود طويلة، عبر حكومات ضعيفة أو فاسدة أو مرتهنة للخارج، أو عبر نخب فاقدة للرؤية لا تملك مشروعًا وطنيًا ولا قدرة على بناء مؤسسات فعّالة تعيد للدولة مكانتها. وهذا “التواطؤ غير المعلن” بين الخارج والداخل هو الذي أنتج حلقة التخلف المزمنة: الخارج يفرض شروطه، والداخل — في كثير من الأحيان — يوقّع عليها طائعًا أو مكرهًا؛ الخارج يستغل، والداخل لا يقاوم؛ الخارج يصنع قواعد اللعبة، والداخل يقبل بها كما هي.
لكن المدهش — في المقابل — أن التجارب العالمية تُظهر أن كسر هذه الحلقة ليس حلمًا، بل حقيقة أثبتتها نماذج حية في عصرنا الحديث. دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا ورواندا كانت أكثر فقرًا واضطرابًا من كثير من بلداننا، لكنها وجدت لحظة فارقة في تاريخها قادها فيها زعماء يعرفون ماذا يريدون، ويملكون الإرادة والعدل والحسم. هناك فقط تغيّر كل شيء. الخارج لا يُهزم بالخطابات، بل بالنجاح الداخلي الذي يفرض نفسه على العالم؛ والعالم لا يحترم الضعيف مهما اشتكى، ولكنه ينصت إلى القوي حين ينهض على قدميه ويعيد ترتيب بيته من الداخل.
ويمكن القول إن الواقع لا يُفسَّر بمدرسة واحدة ولا بفكرة واحدة، بل بمزيج مركّب يجمع بين العاملين معًا: الخارج الذي صنع التبعية، والداخل الذي سمح باستمرارها. ومع ذلك، فإن نقطة البداية — في كل نهضة حقيقية — تبدأ دائمًا من الداخل، من إرادة وطنية صلبة، ومن قيادة تدرك حجم اللحظة التاريخية، وتعيد رسم موقع بلادها في العالم من موقع الندّ لا التابع، وتبني اقتصادًا منتجًا يحمي السيادة الوطنية، وتفرض على القوى الكبرى التعامل معها وفق قاعدة “مكسب مقابل مكسب”، لا “استغلال مقابل صمت”.
وحين ننظر إلى أسباب تخلفنا بميزان العقل لا بميزان العاطفة، ندرك أن الطريق ليس في إلقاء اللوم كله على الخارج، ولا في تبرئة الداخل من كل مسؤولية، بل في تبني رؤية وسطية ناضجة تعتبر التخلف ظاهرة ذات جذرين لا جذر واحد: منظومة دولية غير عادلة، وبُنى داخلية مختلّة. وبين هذين الجذرين يمتد طريق النهضة طريق يبدأ بإعادة بناء الدولة من الداخل، وينتهي بفرض احترامها على الخارج. فلا أحد يمنح الضعيف مكانًا، لكن العالم كله يفتح الأبواب حين يرى دولة تعرف ماذا تريد، وتصنع لنفسها مكانًا لا ينتظر هدية من أحد.